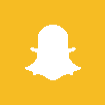من الكتاب الأدبي إلى الكتاب الفلسفي
كانت الكتب الفلسفية الخمسة: (الفلسفة العربية عبر العصور) من تأليف: رمزي نجّار، و(في الفلسفة الإسلامية) من تأليف: إبراهيم مدكور، و(تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية) من تأليف: مصطفى عبدالرازق، و(مبادئ الفلسفة) من تأليف ا. س. رابوبرت، ترجمة: أحمد أمين، و(رواد المثالية في الفلسفة الغربية) من تأليف: عثمان أمين، هي الأبجديّات الأولى لي في هذا العالم الفلسفي المجهول. وإذ أعود بذاكرتي اليوم إلى ذلك اليوم الذي قرأتها فيه؛ أدرك أني لم أنتخبها عن سابق معرفة بمحتوياتها، ولا بأهمية المؤلفين، وإنما لمجرد أن لفظة (الفلسفة) كانت تُعلن عن نفسها في متن عناوينها؛ فضلاً عن توفرها في المكتبة العامة التي كنت أبحث عن الكتاب الفلسفي فيها، والتي كانت ترسم الحدود الأولى لميداني القرائي.
بطبيعة الحال، ألقيت – كالعادة – نظرة مُتصفّحة على الفهرس؛ لأعرف الخطوط العريضة للمحتويات، وهذا ما رشّحها لتكون وجبة الاستعارة الفلسفية العارضة، إذ وجدتها تُؤرّخ لفترات طويلة من تاريخ الفلسفة، أو تقدم مختصراً عاماً؛ دون أن تقتصر على موضوع واحد أو على فيلسوف واحد. وهذا كان شرطاً مبدئياً، إذ كنت أعي – بشكل غير منهجي - ضرورة عدم الدخول في تفاصيل هامشية، أو حتى مهمة؛ قبل الإلمام بالخطوط الرئيسية التي هي – لمن هو في مثل حالي - بمثابة المُقدّمات الضرورية لفهم وتكييف كل التفاصيل التي أخطط للقراءة فيها لاحقاً.
لقد شجعني على المضي في هذا المضمار أن الكتاب الأول الذي بدأت به هو كتاب رمزي نجّار: (الفلسفة العربية عبر العصور)، الذي يكاد يكون تاريخ فلسفة أكثر مما هو فلسفة (مع أن الفلسفة في النهاية ليست إلا تاريخ الفلسفة)، والأهم، أنه كُتب بأسلوب أدبي واضح، مُستعرضاً المؤلفُ فيه – على نحو تعليمي/تبسيطي – أهم المعالم الرئيسية للمذاهب الفلسفية الأولى. ومما شدني إليه أكثر أنه تحدث عن أبي العلاء المعري (شاعري المفضل بعد المتنبي) كفيلسوف، فأغراني ما أعرف وما أحب، بما لا أعرف ولا أحب؛ إلى أن تحوّل العابر في طريق المحبة/اللاّمحبوب الظرفي إلى سيّد الأهواء!.
نعم، لم أقرأ الفلسفة - ابتداء - عن (حُبّ من أو نظرة!). في البداية لم تكن ثمة علاقة حُبٍّ تربطني بالفلسفة من حيث هي فلسفة، بل علاقة واجب؛ حتى وإن تطوّرت فيما بعد إلى علاقة حب ينمو مع كل قراءة. ومن هنا، فإن بداية قراءتي في الفلسفة تختلف كثيراً عن بداية قراءتي في الأدب. فبينما ارتبطت بدايتي مع الأدب بعلاقة عشق وهيام، بل وهوس أشبه بالجنون، ارتبطت بدايتي مع الفلسفة بعلاقة تقديس الواجب المعرفي، إذ كانت هذه البداية التي هي محض اختيار ذاتي، بداية شِبْه مفروضةٍ عليَّ؛ فقد كان منطقي المتضمن لسلوكي القرائي آنذاك يقول – مُتَعشّقاً -: مِن أجل "عين الأدب" تُكرم "ألف عين للفلسفة"!. وهكذا، فالتلازم بين الأدب - قديمه وحديثه، إبداعه ونقده - والفلسفة، هو ما دفعني – بقوة الواجب المعرفي - لسبر أغوار هذا العالم الذي لم أكن لأتكلف عَنَاء ارتيادِ عوالمه الوعرة، ومنها إلى الأشدّ وُعورة؛ لو لم يكن الأدب لا يسخو بأن يفتح لي جميع أبوابه – المباشرة واللاّمباشرة - إلا والفلسفةُ شفيعٌ مصاحب لي في كل دروبه التائهة بين الحقيقة والخيال.
وإذا كان كتاب رمزي نجّار توافق تماماً مع ميولي الأدبية، فإن بقية الكتب المذكورة لم تكن مُنفّرة، رغم بعض الصعوبات التي تكتنفها، والتي ترتبط بطبيعة القضية الفلسفية، أكثر مما ترتبط بأسلوب المؤلف أو بطريقة عرضه للأفكار والقضايا. وكما قلتُ من قبل، لم أسمح للصعب أن يكدر عليّ لذة السهل؛ فكنت أتجاوز تلك الصعوبات القليلة التي تدخل في مجال التفاصيل الضرورية؛ لأظفر برؤية عامة/شمولية عن كل قضية، موقناً أن ما لا يُفهم من هذه القراءة الأولى، سيُفهم من قراءة أخرى، وما لا يُقرّبه هذا الكتاب؛ سيقرّبه كتاب آخر في مستقبل الأيام.
لقد كنت محظوظاً أن كانت هذه الكتب هي التي عرّفتني على الفلسفة؛ لا لكونها مَصوغة بأسلوب واضح وجذّاب فحسب، وإنما – أيضا - لأنها مكتوبة بأقلام مُتخصّصين في هذا المجال، وبالتالي، مُنحازين إلى الخطاب الفلسفي. ولك أن تتصور العكس، أي لو أن البداية كانت على تلك الكتب المُمعنة في التنظير المتعالي المعقد، أو على تلك الكتب التي تزدري الفلسفة أو التي تُبشّر بموتها، فضلاً عن كتابات التقليديين المنغلقين في القديم والحديث، والتي لا ترى في الفلسفة أكثر من مشروع ضلال وإضلال.
بعد هذه الكتب التي مهّدت وقرّبت لي كثيراً مما كنت أراه عسيراً وبعيداً، ووضعت لي معالم أولية في الطريق، عثرت – مصادفة – على كتاب عمر فرّوخ: (تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون)، بينما كنت أبحث عما يروقني من الكتب الأدبية والفكرية. وكتاب فرّوخ كتاب ضخم، أهم ما فيه – في تصوري آنذاك – ما كتبه في المقدمة أو التمهيد (أذكر أنه تمهيد طويل، في حدود 150 صفحة) عن الفلسفة السابقة للفلسفة الإسلامية، وخاصة عن الفلسفة اليونانية، إذ كان – كما بدا لي في تلك الفترة، وكما أتذكر الآن - في غاية الوضوح أسلوباً وتنسيقاً. وقد مكثت فترة تمتد لشهرين أو ثلاثة بعد قراءة هذا الكتاب، قبل أن أكتشف الفيلسوف الأديب: زكي نجيب محمود، الذي بدأت القراءة له بكتابين كتبهما عن حياته الروحية والعقلية: (قصة نفس)، و(قصة عقل). وقد كانت تجاربه العقلية التي عرضها بالتفصيل والتحليل مُلهمة لمن هو في مثل حالي. لقد كنت أحتاج لمثل هذا الأسلوب، كما كنت أحتاج لمثل هذه التجارب؛ لأستمر في هذا الطريق الذي يُنازعني عشقي الأدبي.
لقد أغراني زكي نجيب محمود بعالم الفكر، وكشف لي أنه عالم شاق، ولكنه – في الوقت نفسه - ممتع؛ بقدر ما الأدب ممتع. وبإغراء هذين الكتابين قرأت له: (تجديد الفكر العربي)، و(خرافة الميتافيزيقيا)، و(ثقافتنا في مواجهة العصر). وأعتقد فيما يشبه الجزم أنني كنت سأزْوَرُّ عنه كثيرا، وأني سأمكث وقتا طويلا قبل أن أعود إليه مقتنعا بقيمته كفيلسوف/أديب؛ لو أني بدأت القراءة له بكتابه: (خرافة الميتافيزيقيا)، فقد كان كتاباً جَافّاً جافِياً يتعارض – إلى درجة التضاد - مع المنحى الفكري العام الذي كنت أنظر للوجود من خلاله في تلك الأيام.
رغم كل هذه القراءات الاستكشافية المُغرية التي بدأت فيها بارتياد عالم الفلسفة، ورغم كل ما توالد عنها من تقدير وإعجاب بالفلسفة والفلاسفة، ورغم ما خلقته من أشواق وأشواق، لم يفتر حماسي للأدب، ولا لما يتصل به من نقد وتاريخ. بل أستطيع القول إنها أغرتني بالأدب أكثر فأكثر. لقد حفّزتني بعض القضايا التي أخذت طباع الإشكال الفلسفي إلى مراجعة بعض ما قرأته هنا وهناك في الأدب والنقد الأدبي. وأذكر أنني وأنا أقرأ هذه الكتب الفلسفية وأكتشف فيها كثيرا مما هو جديد عليّ؛ كنت أقرأ في كتابين مُهمين في النقد الأدبي: (مناهج النقد الأدبي) لديفيد ديتش، و(النقد الأدبي ومدارسه الحديثة) لستانلي هايمن. وقد حاولت – قدر جهدي ومعرفتي – أن أربط بين بعض المسائل والإشكاليات هنا وهناك، وقد كتبت بعض الملخصات المختصرة التي ظننت أنني سأستفيد منها لاحقاً في استذكاري، أو في بحوثي المتوقعة/المأمولة. غير أن قراءاتي بعد ذلك زهّدتني في قيمة ما اختصرته ابتداء، إذ اتضح لي وجود كثير من الثغرات المعرفية الناتجة عن كوني خاضعاً لتوصيف أبي نواس في شطره الشهير: "حفظت شيئاً وغابت عني أشياء".
أيضا، في هذه الأثناء، لم أنقطع عن قراءاتي في الفكر الإسلامي، خاصة الذي كتبه رموز الحركية الإسلامية، رغم أن هذه الفترة مَثّلت بداية إحساسي بتفاهة ما كُتب في هذا المجال. لقد كانت المكتبة العامة متخمة بكتب الإخوان خاصة، ورموز الحركات الإسلامية عامة. لقد كان من أول ما قرأت في هذه الفترة، كتاب صلاح شادي: (صفحات من التاريخ)، وكتاب سعيد حوى: (المدخل إلى دعوة الإخوان) وكتب جابر رزق عن مذابح الإخوان ومآسيهم في المعتقلات، وكتاب زينب الغزالي: (أيام من حياتي)، ثم مباشرة انخرطت في قراءة كتب حسن البنا، وسيد قطب، ومحمد قطب، ومحمد الغزالي، والمودودي، والندوي، وأنور الجندي، وعلي الطنطاوي...إلخ. بالنسبة لحسن البنا، قرأت له: (مذكرات الدعوة والداعية) ثم (رسائل الإمام الشهيد) أكثر من مرة؛ لأربط تفاصيل الدراما الإخوانية ببداياتها. أما سيد قطب، فربما كان كتابه: (العدالة الاجتماعية في الإسلام) أكثر ما شدّني إليه. وتبقى كتب محمد قطب: (واقعنا المعاصر)، و(جاهلية القرن العشرين)، و(التطور والثبات في حياة البشرية) من الكتب التي أثارت لديّ كثيرا من الأفكار المتضاربة، إذ كُتبت برسم الدفاع عن الإسلام، وكان هذا يروقني كثيرا، ولكنها تشتعل بحالة انغلاق على الذات، وازدراء لكل ما لدى الآخر من أفكار، وكأن الأنا ملاك، والآخر شيطان، وكان هذا التعصب والفخر الغبي يُغضبني كثيرا. وطبعا، بين ذاك الرضا وهذا الغضب، كانت ثمة مسافات ومسارات لا يتسع لها هذا المجال!
ما أريد التأكيد عليه بهذه المناسبة أن الأفكار المُحرّضة، ومهما كانت متطرفة، لا تُؤثر إلا في المنغلقين عليها نفسياً وفكرياً. في الأربع أو الخمس سنوات الأولى من بدياتي في القراءة، والتي تشمل أخطر مراحل التأثر، كنت قد قرأت أكثر من 150 كتاباً من كتب المتأسلمين الحركيين. ومع هذا، لم تستطع كل هذه الصفحات المُحرّضة أن تقودني نحو التطرف، لا لشيء، إلا لأنني كنت منفتحاً – قرائياً – على ميادين واتجاهات شتى تتضاد في معظمها من الانغلاق. ومن هنا، فإن أخطر الأطروحات لن تفعل فعلها السلبي إلا في بيئة محكومة بالجهل. ما يعني أن منع الكتب في (زمن اللاّمنع) ليس هو الحل لمكافحة مضامين الكتب الانغلاقية أو التحريضية، بل الحل – في تقديري - يكون بفتح آفاق العقول على مجالات متنوعة، وآراء متعارضة/متناقضة، بحيث تُزعْزع صلادة اليقين الدوغمائي المتضمن في مقولات المتطرفين.
إن كل هذه القراءات على أهميتها ودورها في إثرائي المعرفي والروحي، لم تكن إلا مقدمة مسكونة بالحيرة والقلق؛ بقدر ما هي مسكونة بالمعرفة أحيانا، وبوهم المعرفة في أحايين أخرى. كل هذه القراءات لم تستطع أن تمنحني معرفة واضحة أعتقد بها – ومن خلالها - أن التنوير ضرورة حياتية، وبالتالي ضرورة فكرية، وأن القلم إن لم يسهم في شيء من التنوير، فهو يُسهم – بالضرورة - في ترسيخ معالم البؤس في حياة البشر؛ بالمقدار الذي يدل عليه السياق: مكان الصمت وزمانه. لقد تعرفت على شيء من جديلة الأفكار، سواء في إطار المقروء الفلسفي، أو في إطار المقروء الإيديولوجي الخالص، ومنه الحركي الإسلامي. ولكن ربطها بتاريخ متسق من النضال في سبيل التخفيف من حدة وطأة البؤس الإنساني، لم يكن ليتضح لي على الصورة التي تضعني على طريق التنوير إلا بعد قراءتي لكتاب كرين برنتن: (أفكار ورجال).
نقلا عن الرياض
لا يوجد تعليقات